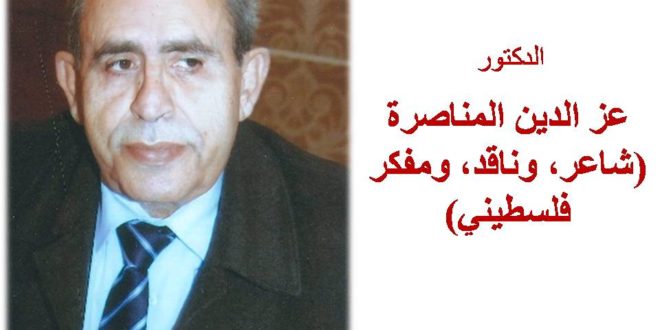
* مراجعة الدكتور عزالدين المناصرة
– نحن الآن، نعيش في البلدان العربية، زمنياً، كما عاشت فرنسا في النصف الثاني من ستينيات القرن العشرين من زاوية هيمنة “التقنيات التربوية'”، و”‘المناهج'”، بتأثير “الحاسوب” و”الإنترنت”، والفارق بيننا وبين فرنسا التعليمية والثقافية، أننا نعيش مرحلة الدهشة والرغبة؛ في حين كانت فرنسا في ستينيات القرن الماضي، تطبّق النظريات التقنية في التعليم والثقافة والأدب، بتأثير “البنيوية”، تطبيقاً عملياً. ونحن هنا لا نناقش ولا ننفي أهمية الحاسوب والإنترنت في تسريع العملية التربوية التعليمية الثقافية، فهذا أمر بدهي، ولكن عندما تصبح هذه “التقنيات” هدفاً بحدّ ذاته، وغاية نهائية، فنحن نحتجُّ هنا، ونعلن: “نخشى أن تتحول جامعاتنا إلى مدارس ابتدائية عُليا”، كما كتبتُ ذات مرّة، وأضيف: “نخشى أن تتحول مدارسنا إلى كتاتيب، تعلّم التقنيات التربوية”، ومن يراجع كتبي النقدية التي ناقشتْ “الحداثة وما بعد الحداثة”، مثل: (النقد الثقافي المقارن)، و(نظرية الأدب)، وغيره، يُدرك أنني صرّحتُ أكثر من مرّة، “ضدَّ تقديس الحداثة التقنية” في الأدب. والسبب هو أنني تعرَّفت إلى “البنيوية”، و”السيميائية”، مبكّراً في النصف الثاني من السبعينيات، وعرفتُ آنذاك التأثير الطاغي لعلم اللسانيات في نقد النصوص. وهكذا، انطلقتُ في قراءة “البنية”، و”التقنيات” من “موقف نقدي”، لا من موقف الدهشة والتقديس.
النقد العربي الحديث في بداية الثمانينات، كان أمام مفترق طرق:
أولاً: كان النقد التقليدي، يسير باتجاه تاريخ الأدب، ووظيفة الأدب الاجتماعية والسياسية، أي قراءة التاريخ الاجتماعي والسياسي والتاريخي، الذي يُحيط بالنصّ، أي ما يُسمّى “قراءة الأدب من الخارج”، حيث يسود “التعليق النقدي” التفسيري الانطباعي، والثرثرة التاريخية الجغرافية الاجتماعية. وهكذا أصبح النصّ، مجرّد ذريعة لقول غير أدبي. وسادت نظرية التحقيب الألمانية للأدب إلى عصور مرتبطة بالحكّام والدول، أو بالمفاصل التاريخية السياسية.
ثانياً: يمكن الإشارة إلى أن بدايات البنيوية في النقد العربي الحديث، بدأت في النصف الثاني من السبعينيات في بعض الكتب الصادرة في الأقطار المغاربية ولبنان، على وجه التحديد، أما في الثمانينيات والتسعينيات، فقد ازدهرت حركة الترجمة “غير اللّينة” لبعض الكتب الأجنبية في مجال البنيوية، وتلتها موجة السيميائية. وقد شعر الأشقاء من “الأكاديميين المغاربة”، بشيء من الزهو غير الموضوعي، بمعرفتهم بالمناهج والتقنيات الفرنسية، حتى إنّ بعضهم في المؤتمرات، كان ينتقد أيّ “ضيف مشرقي”، بالقول: “إنّه بلا منهج”.
آنذاك كنتُ أستاذاً بالجامعات الجزائرية (1983-1991). وهكذا أصبحت “التقنيات” مقدّسة، وأصبحت “الجامعات المشرقية”، تلهثُ بصعوبة وراء هذه التقنيات، لعدم معرفتها بالفرنسية (أصل هذه المناهج والتقنيات). ولهذا كان الاعتماد على الكتب المترجمة، ترجمةً رديئةً للقارئ، والأخطر من ذلك، هو أنها أصبحت هدفاً وغاية، حتى إن النصوص الممتازة والرديئة، تساوت في التحليل، ما دام النصُّ، مجرد كتلة لغوية مغلقة وباردة.
ثالثاً: النصوص المدروسة إيديولوجيةٌ بامتياز. إنها إيديولوجيا التقنيات، وإيديولوجيا “الولاء للسلطة”، بما يخالف أبسط قواعد الليبرالية الوطنية، أي “التعددية النوعية، والحرية والديمقراطية”. وهكذا انتقلت المناهج والنصوص من “الأخلاق” و”التاريخ” إلى “البنيات”، و”التقنيات الحرفية البائسة”. فالتطرُّف في الثرثرة التاريخية والاجتماعية السابق، قابله تطرُّف في تأليه التقنيات والمناهج الذهنية المجرّدة. لهذا جاء الطلبة من المدرسة إلى الجامعة، وهم كارهون للأدب ونصوصه، لأنهم لم يقرأوا نصوصاً ممتازة ذات شاعرية عالية في المدرسة، لأن السلطة تروّج لنصوص شعرائها.
رابعاَ: كانت في المناهج المدرسية الأردنية، مواد، تمَّ حذفها، مثل: “الفلسفة”، و”قضية فلسطين”، ورفضت المناهج المدرسية حتى الآن، إدخال مادّة “ثقافة الجسد”، حتى كتشريح طبّي للذكر والأنثى، لهذا يجيء الطالب إلى الجامعة مكبوتاً ومعقّداً، وخجولاً، إذا ما ورد مثلاً، “إيماء” أو “إيحاء” جنسي في نصّ من النصوص الأدبية أو الثقافية، أو يبتسم ابتسامة تحتانية خجولة، أو وقحة. ويجيء الطالب إلى الجامعة، وهو لا يعرف الاتجاهات الفلسفية السائدة في العالم، ولا حتى اسم فيلسوف واحد، فكيف إذن نشرح له “علم الجمال التشكيلي” مثلاً.
نهاية ثقافة الحرب الباردة
صـدر مؤخـراً كتــاب “الأدب في خطــر” (La Littérature en Péril)، للناقد العالمي البلغاري المتفرنس، “تسفيتان تودوروف”، باللغة الفرنسية، في العام 2007، وترجمه إلى العربية: عبد الكبير الشرقاوي، وصدرت الترجمة في العام نفسه فالعنوان “الأدب في خطر”، هو عنوان مثير، وكاتبه ناقد شهير.
– يسرد تودوروف في “التمهيد”، قصّة انتقاله من بلغاريا إلى فرنسا في العام 1963، وكيف درس المرحلة الجامعية الأولى في جامعة صوفيا، ثمّ كيف تعرّف إلى “رولان بارت”، و”جيرار جُينيت” في باريس، وكيف حصل على دكتوراه أولى (1966)، تحت إشراف جُينيت، ثم انتقل إلى العمل في “المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي” (CNRS)، وبقي فيه طيلة مساره المهني. ولم يمارس تودوروف التعليم في المدرسة أو في الجامعة إلاّ قليلاً. وأشرف مع جُينيت على مجلة “الشعرية” (poétique)، وأصدر في العام 1965، ترجمة إلى الفرنسية لنصوص (الشكلانيين الروس)، تحت عنوان: “نظرية الأدب”.
ثم توالى صدور كتبه: “نقد النقد”، “فتح أميركا”، “مغامرات المطلق”، “وجه التطرف”، وغيرها. أماّ عن مرحلته البلغارية في “جامعة صوفيا”، فهو يسرد تجربته من خلال “ثقافة الحرب الباردة” بين المعسكرين: الاشتراكي، والرأسمالي، منحازاً للفكر الرأسمالي الشكلاني، وبهذا الصدد يقول:
أولاً: لأني لا أشارك الإيمان الشيوعي في بلغاريا آنذاك، ولا تحركني روح التمرّد، لجأت إلى موقف: “الإذعان الصامت للشعارات الرسمية” الاشتراكية، أمّا في السرّ، فقد كانت هناك “حياة كثيفة من اللقاءات والقراءات المتوجهة نحو مؤلفين، ليسوا شيوعيين”.
ثانياً: لجأت في بحث التخرج في “جامعة صوفيا” إلى الاهتمام بموضوعات دون حمولة أيديولوجية: التحليل النحوي، وعلم العروض. وهكذا أفلتُّ من الفصام الجماعي، الذي يفرضه النظام الشمولي البلغاري. وهكذا، صار من عادتي التعرف إلى عناصر الأعمال الأدبية المتخلصة من الأيديولوجيا: الأسلوب، التركيب، الأشكال السردية، وباختصار: “التقنية الأدبية” في المرحلة الفرنسية.
ثالثاً: في مرحلة لاحقة، أي منذ منتصف السبعينيات، يقول تودوروف، إنه بدأ يقرأ النصوص المتنوعة: سيراً ذاتية، مذكرات، مؤلفات تاريخية، شهادات، تأملات، رسائل، نصوصاً فلكلورية مجهولة المؤلفة، لم تكن تشارك الأعمال الأدبية، وضعية التخييل. وهكذا اتّسع عنده حقل الأدب.
– هنا يمكن أن نقدّم الملاحظات التالية على أقوال تودوروف:
أولاً: هناك مبالغة واضحة في نقد “تعليم الأدب في جامعة صوفيا”، بأنه تعليم أيديولوجي، ينطلق من علم الجمال الماركسي، فحسب، فكيف غفل هذا التعليم الإيديولوجي عن التحليل النحوي، وعلم العروض، دون إخضاعه للتحليل الجدلي أيضاً. لقد كان تودوروف في مرحلة البكالوريوس، ولا أظنّ أنه في هذه المرحلة، أدرك مفهوم التقنيات الحيادية من وجهة نظره، في مقابل علم الجمال الماركسي الإيديولوجي، وهو قد أدرك “لاحقاً”، أنّ التقنيات الأدبية، هي إيديولوجية شكلية أيضاً، أي أيديولوجيا في مقابل أيديولوجيا. لقد عشتُ تجربة تودوروف نفسها، ولكن في زمن آخر، ومرحلة أخرى هي “مرحلة شهادة التخصص”، ومرحلة “شهادة الدكتوراه”، وفي الجامعة نفسها، أي جامعة صوفيا، ورغم الفوارق الزمنية، فقد كان علم الجمال الماركسي، هو المعتمد، عندما نوقشت أطروحتي للدكتوراه في العام 1981، بل هو النظام السياسي نفسه الذي درس تودوروف في ظله بجامعة صوفيا.
ثانياً: رغم أن تودوروف، رسم أجواء كابوسية لتجربته في جامعة صوفيا، ولعلاقة بلغاريا بفرنسا آنذاك (عام 1963)، إلا أنه يعترف: “كانت لديّ توصية من عميد كلية الآداب في جامعة صوفيا إلى نظيره في جامعة السوربون”.
وهو أيضاً يقول: “كان نصف دروس الأدب علماً متعمقاً في جامعة صوفيا، أما النصف الآخر، فهو دعاية إيديولوجية”. فالعلم المتعمق في جامعة صوفيا، بالنسبة لتودوروف، هو: علم النحو، وعلم العروض، وعلم الأسلوب، والتركيب، والأشكال السردية، رغم أن علم الجمال الجدلي يتعامل إيديولوجياً مع هذه العلوم أيضاً، فكيف يفصلها عن قراءة النصوص الأدبية “الإيديولوجية!!”، فعلم الجمال الجدلي لا يقبل بذلك، أصلاً.
ثالثاً: أعتقد جازماً أن تودوروف، لم يحتجّ على علم الجمال الماركسي، ولا حتى كان منحازاً للتقنيات الأدبية في مرحلة “جامعة صوفيا”، وإنما هو انحاز لها فيما بعد، أي في باريس، انطلاقاً من ثقافة الحرب الباردة. فقد كانت أوروبا، الرأسمالية تُشجّع “ظاهرة الانشقاق الأدبي”، و”ظاهرة الشكلانية” من أجل محو مفهوم الهويّة، أي أنّ تودوروف، انحاز للدعاية الرأسمالية في مقابل العداء للاشتراكية، فالإقامة والجنسية في فرنسا، تتطلّب ذلك.
يقول الشاعر العراقي سعدي يوسف الذي أقام ثلاث سنوات في فرنسا، حرفياً: “تركتُ فرنسا، لأنّ المخابرات الفرنسية، أرادت تجنيدي لأتجسس على العرب المقيمين في فرنسا. اتصل بي شخص مهم من وزارة الداخلية، وطلب مني ذلك بشكل مباشر، ولكنني رفضتُ، وكان عليّ أن أترك باريس”، حيث غادرتها نحو لندن. (صحيفة “أخبار الأدب” المصرية، 25/2/2007).
نقد التقنيات الأدبية
أولاً: يقول تودوروف: أفتح الجريدة الرسمية لوزارة التربية الوطنية الفرنسية (العدد السادس، 2000)، الذي يتضمن برامج المدارس الثانوية، وخصوصاً اللغة الفرنسية، فأقرأ تحت عنوان: “آفاق الدراسة” ما يلي: “تُسهم دراسة النصوص في تكوين التفكير حول التاريخ الأدبي، والثقافي، والأجناس الأدبية، ومستويات الخطاب، وتكوُّن دلالة النصوص، وخصوصيتها، والاستدلال، وتأثيرات كل خطاب في متلقيه”.
ويعلّق تودوروف: “مجموع التعليمات، إذن، يقوم على تعريفنا بالأدوات، التي تستخدمها تلك الدراسات، وهكذا، لا نتعلم في المدرسة عن ماذا تتحدث الأعمال الأدبية، وإنما عن ماذا يتحدث النقاد”، أي أن تودوروف يطالب بالتمييز بين “المهارات، والوسائل والأدوات” وبين “الهدف والغاية”، وهو ينتقد تركيز التعليم على الأدوات والتقنيات والمناهج، حيث لا تقود قراءة القصائد والقصص والروايات إلى التفكير في الوضع الإنساني، والفرد والمجتمع، والحب والكراهية، والفرح واليأس، بل تقود التقنيات إلى تعلّم مناهج نقدية قديمة، وحديثة، كما يقول.
وهو يضيف: “بعيداً عن القدح في علوم مثل: السيميائية، والتداولية، والبلاغة، والشعرية، فكل موضوعات المعرفة هذه، هي أبنية مجرّدة، ومفاهيم صاغها التحليل الأدبي لقراءة الأعمال الأدبية”، وبالتالي، فهي لا تتحدث عن معنى النص، ولا عن عالم النص، لأنّ الأجناس ومستويات الخطاب وصيغ الدلالة وتأثيرات الاستدلال، والاستعارة والكناية، والتبئير الداخلي والخارجي، تتناول وظيفة عنصر من عنصر أدبي في علاقة مع بنيته الكلية، ولا تتناول معنى ذلك العنصر، ولا معنى العمل الأدبي بأكمله في علاقة مع زمانه، أو زماننا. ويواصل تودوروف أسئلته وملاحظاته:
“أدلّة عديدة تجعلني أميل إلى تصور للدراسات الأدبية، وفق نموذج التاريخ، لا وفق نموذج الفيزياء، بوصف أن الدراسة الأدبية تقود إلى معرفة موضوع خارجي هو الأدب”. ثمّ يرمي تودوروف بقنبلته الأولى، مميزاً بين الإبداع والنقد: “نحن -مختصين، ونقاداً، وأساتذة- لسنا في أغلب الأحيان، سوى أقزام، تعتلي أكتاف العمالقة”.
ثانياً: طبعاً، لا ينكر تودوروف، أهمية التحليل البنيوي، لكنّه يعدّ هذا التحليل، مجرد أداة، فهو يقول: “التجديدات التي حملتها المقاربة البنيوية في العقود الماضية، مرحب بها، شرط احتفاظها بوظيفة الأداة هذه، بدلاً من أن تتحول إلى غاية لذاتها”. و”يمكن لمكتسبات التحليل البنيوي إلى جانب مكتسبات أخرى، أن تعين على فهم أفضل لمعنى عمل أدبي، أكثر من الفيلولوجيا القديمة”، ومع هذا -يضيف تودوروف- فهي (مجرد أدوات) لا أحد يعترض عليها، لكنها لا تستحق أن يستهلك الإنسان فيها، جميع وقته. ثمَّ يرمي تودوروف بقنبلته الثانية: “لا ينبغي للوسائل أن تصير غاية، ولا للتقنية أن تنسينا هدف الممارسة.
فالقارئ غير المتخصص، يقرأ الأعمال الأدبية، لا ليتقن بشكل أفضل منهجاً في القراءة، بل ليجد فيها معنى يتيح له فهماً أفضل للإنسان والعالم، وليكتشف فيها جمالاً يثري وجوده، لكي يفهم نفسه بشكل أفضل”، فالتعليم الذي يدير ظهره لهذا المعنى، يقودنا إلى طريق مسدودة.
ثالثاً: هنا يتبادر فوراً إلى الذهن الفكرة المعروفة، وهي أنّ تودوروف، هو أحد أقطاب الشكلانية، والبنيوية، والسيميائية، طيلة الفترة 1965-2007، أي منذ ترجم نصوص الشكلانيين الروس، وحتى “الأدب في خطر”، فكيف يجيء لنا بعد أكثر من أربعين سنة من الدعاية للشكلانية والبنيوية، ليتراجع تراجعاً حاداً نحو “معنى النصّ”، الذي تجاهله سابقاً!.
طبعاً يعرف تودوروف أن القارئ لكتابه، سوف يطرح السؤال بقوة، لهذا يقول: “لقد شاركتُ في الستينيات والسبعنييات، تحت راية البنيوية في هذه الحركة، هل ينبغي لي أن أشعر أنني مسؤول عن حال المادة التعليمية اليوم!”.
وهنا يسرد تودوروف وضعية التعليم الجامعي في الستينيات في فرنسا: “كان الطلبة مطالَبين بأن يصبّوا أنفسهم في إطار تاريخي، ووطني، وكان المتخصصون، بدل أن يتساءلوا طويلاً عن معنى الأعمال الأدبية، يقيمون جرداً شاملاً لكلّ ما يحيط بهذه الأعمال: سيرة المؤلف، الاختلافات بين النسخ، روايات العمل الأدبي، ردود الفعل التي أثارها عند المعاصرين… الخ”. إذن، لم تكن بلغاريا، التي اهتمت بتحليل المعنى في إطار علم الجمال الماركسي، والإطار التاريخي الوطني البلغاري، لم تكن تختلف عن فرنسا، فهي الأخرى، أي فرنسا، إيديولوجية. لأن الجزائر، تحررت ونالت استقلالها، في العام 1962.
رابعاً: يقدّم تودوروف اقتراحاً، بشأن تعليم الأدب في المدرسة والجامعة، هو: “من المشروع في التعليم الجامعي، تدريس المقاربات، والمفاهيم، والتقنيات إلى جانب تدريس الأعمال الأدبية. أما التعليم الثانوي، غير الموجّه للمختصين في الأدب، بل للجميع، فلا يمكن أن يكون له الموضوع نفسه، فالأدب نفسه، هو الموجّه إلى الجميع، لا الدراسات الأدبية، فمن الأولى إذن، تدريس الأدب، لا الدراسات الأدبية”. ثمّ يؤكد تودوروف أن التصوّر المختزل للأدب ليس موجوداً في المدارس والجامعات فقط، بل هو “ممثّل بغزارة بين الصحافيين الذين يقومون بعرض الكتب، بل بين الأدباء أنفسهم”. ثمّ يصنّف تودوروف (الواقع الأدبي في فرنسا حالياً (2007))، بأنه ينقسم إلى ثلاثة تيارات:
- التصوُّر البنيوي.
- التصوُّر العدمي.
- تيار الأنانة الأحادية (Solipsism)، وهو مذهب يقرُّ أن “الأنا”، وحده هو الموجود، وأنّ الفكر لا يدرك سوى تصوراته. (انظر: معجم المنهل – فرنسي- عربي، لسهيل إدريس، وجبّور عبد النور، بيروت، 1983، ص 962).
خامساً: ثمّ يناقش تودوروف، تحت عنوان “نشوء علم الجمال الحديث”، الأطروحة التي مفادها أنّ الأدب، ليس مرتبطاً بعلاقة ذات دلالة مع العالم، وبالتالي، فالحكم عليه، ليس له أن يأخذ بالحُسبان ما يقول لنا عن ذلك العالم. وهو يقول إن هذه الأطروحة ذات تاريخ طويل ومعقّد، ظهرت موازيةً لتاريخ نشوء الحداثة، لهذا يناقشها تودوروف مطولاً، منذ أرسطو “المحاكاة”، ومنذ هوراس “المتعة والفائدة”، مروراً بـِ”بوالو”: لا شيء أجمل من الحق، والحق وحده معشوق، ثمّ أوغسطين، الذي نقل المقولات الأفلاطونية إلى المجال الديني.
ثمّ كتابات شافتسبري في علم الجمال، وحتى الألماني “باومجارتن”، الذي ابتدع مصطلح “علم الجمال”، في العام 1750. ثمّ يناقش تودوروف “جماليات عصر الأنوار”، حيث استقلالية الفرد، وتمييز “فيكو” بين اللغة العقلية، واللغة الشعرية في كتابه: “العلم الجديد” (1730)، كذلك “ليسنغ” في “اللاوكون” (1766)، حيث يعدّ تودوروف عبارة ليسنغ: “الفن لأجل ذاته”، ربّما هي أصل نظرية “الفن للفن”، فما يجعل من شكسبير كاتباً عظيماً، عند ليسنغ، هو أن لديه:
“رؤية عميقة لجوهر الحُبّ”. ويؤكّد تودوروف أن عبارة “الفن للفن” في الفرنسية، ظهرت في العام 1804 في كتابات بنيامين كونستان، وأنّ كونستان، كان عدوّاً للنزعة التعليمية في الأدب، غير أنه لا يعدّه مفصوماً عن العالم، وأنّ الأدب متصل بكل شيء، ولا يمكن فصله عن السياسة والدين والأخلاق، وبالنتيجة، حسب كونستان: “لا يوجد شعر صافٍ، كل شعر بالضرورة، هو غير صافٍ”. ثمّ يناقش تودوروف “علم الجمال الرومانسي”، و”الحركات الطليعية”، التي ظهرت منذ مطلع القرن التاسع عشر: (شليجل، شيلينغ، نوفاليس). ويناقش “بودلير”، الذي يرفض أن يرى الشعر سبيلاً لمعرفة العالم، يقول بودلير: “الشعر، ليس موضوعه الحقيقة، لا موضوع له إلاّ ذاته. صيغ البرهنة على الحقيقة مُغايرة، ولها موضع آخر، ولا صلة للحقيقة بالأغنيات”، وقول “كيتس”: الجمال هو حقيقة، والحقيقة هي جمال، وقول “أوسكار وايلد”: “الحياة تحاكي الفن، أكثر مما يحاكي الفن الحياة”. ويؤكّد تودوروف أن القطيعة الحاسمة، لم تحدث إلاّ في مطلع القرن العشرين، بتأثير أطروحات “نيتشه” الجذرية، التي تضع موضع السؤال، الوجود نفسه للوقائع معزولة عن تأويلاتها، ووجود الحقيقة، أياً كانت.
سادساً: يصل تودوروف إلى القرن الواحد والعشرين، حيث يُهيمن ثالوث “الشكلانية، العدمية، الأنا الأحادية”، في فرنسا على مواقع مهيمنة إيديولوجياً -والكلام دائماً لتودوروف- فلهم الأغلبية في هيئات تحرير الصحف الأدبية، وبين مديري المسارح المدعومة، أو المتاحف، وعندهم أنّ الصّلة الظاهرية للأعمال الفنية بالعالم ما هي إلاّ وهم، مما ينتج صورة كاريكاتيرية للأدب في فرنسا.
سابعاً: يقول تودوروف إن الأدب يستطيع الكثير. يستطيع أن يمُدّ لنا اليد حين نكون في أعماق الاكتئاب، ويقودنا نحو الكائنات البشرية من حولنا، ويجعلنا أكثر فهماَ للعالم، ويعيننا على أن نحيا. فالقارئ العادي، الذي يستمر في البحث ضمن الأعمال التي يقرها عن ما يمنح معنى لحياته، هو على صواب، عندما يكون ضدّ “الأساتذة والنقاد والكُتّاب”، الذين يقولون له إنّ الأدب لا يتحدث إلاّ عن نفسه، أو لا يُعلّم إلاّ اليأس. الأدب هو فكر ومعرفة للعالم النفسي والاجتماعي الذي نسكنه، أما “الواقع”، الذي يطمح الأدب إلى فهمه، فهو التجربة الإنسانية. الأدب يجعلنا نحيا تجارب فريدة، أما الفلسفة، فتعالج المفاهيم.
ثامناً: يقول تودوروف: كل المناهج جيّدة، بشرط أن تظلّ وسيلة، بدل أن تتحول إلى غاية في حدّ ذاتها. ومَهمّةُ الناقد، هي تحويل المعنى في النصّ إلى اللغة المشتركة في عصره، وليس مُهماً معرفة الوسائل التي يبلغ بها هدفه. “إنّهم يغتالون الأدب”، لا بدراسة نصوص “غير أدبية” في المدرسة، بل بجعل الأعمال الأدبية، مجرد جملة إيضاحية لرؤية شكلانية، أو عدمية، أو “أنانية” للأدب. إنه يلزم إدراج الأعمال الأدبية في الحوار العظيم للبشر، لكي تكون الحياة أفضل.
خاتمة: لا سقفَ للسماء
سبق لي أن قدّمتُ اقتراحاً بضرورة انعقاد مؤتمر تحت عنوان: “قراءة النصوص الأدبية واللغوية في المناهج المدرسية في الأردن”، ويمكن توسيعه إلى قراءة النصوص في المناهج المدرسية في البلدان العربية، ولكن، للأسف، لم أستطع إقناع الآخرين به. ثمّ اقترحتُ مناقشة الموضوع في ندوة مُصغّرة على أن تكون بعنوان: “مناهج الأدب واللغة في الجامعات”، لكنني فشلتُ مرّة أخرى في إقناع الآخرين، لأسباب لا مجال لذكرها، أهمها خوف مثقفي السلطة.
أما هذه المرّة، فسأقوم “بتكبير حَجَري”، وأقترح مناقشة: “قراءة النصوص الأدبية واللغوية في المناهج المدرسية والجامعية في الأردن: التقنيات والغايات”، ليكون مؤتمراً تتفاعل فيه المدرسة مع الجامعة على المستوى الوطني العام في الأردن، مقترحاً أن تتبنّاه إحدى الجامعات في الأردن، وأقدّم الملاحظات التالية:
أولاً: لقد لعبتْ “البنيوية، والسيميائية”، دوراً مهماً في الخلاص من الثرثرة الاجتماعية والسياسية حول النصّ، هذه الثرثرة التي مارسها النقد التقليدي التاريخي، حيث اتجهنا نحو “النصّ، ولا شيء غير النصّ”، ولكنّ بعضنا فهم خطأ أنّ النص لا علاقة له بالعلوم الإنسانية، فخسرنا فهم جوهر عالم النص، فالعلوم الإنسانية التي ينتجها النص، يمكن أن تحيل إلى فهم أفضل للنص، لكنّ هذه العلوم، لا يجب “إسقاطها” على النصّ من الخارج، بل ينبغي الإحالة إليها من الداخل. هكذا تستقيم علاقة النص بالعلوم الإنسانية، وليس كما فهمها تودوروف، بأنها تعني دراسة “السياق التاريخي، والأيديولوجي، والجمالي”، لأنه يُخشى أن نعود إلى الثرثرة، أي يفترض أن يكون “السياق”، هو “سياق النص”، وليس “سياق ما حول النص”.
ثانياً: المناهج، والتقنيات، والحاسوب، والإنترنت، أدوات، مجرد أدوات تساهم في معرفة النص، ولا ينبغي أن تتوقف عند هذه المعرفة بحيادية باردة، بل أن تكشف “المسكوت عنه” في اختيار النصوص في المناهج، وأسباب هذا الاختيار: هل هو الولاء لسلطة الجمال، أم الولاء لسلطة السلطة السياسية والدينية، والأخلاقية: (قصيدة أحمد شوقي “يا جارة الوادي”، أجمل شعرياً، من كل قصائده الأخلاقية). وينبغي أن تعالج المناهج إشكالية الثالوث المحرّم: “الجنس، السياسة، الدين”، بأسلوب علمي، بعيداً عن فكر “السلفية المحافظة”، وبعيداً عن فكر “الليبرالية التابعة”.
إنّ تحوّل الكلام عن تطوير المناهج في المدارس والجامعات إلى “خطاطات شكلية باردة”، ترسم الأهداف والغايات، ولا تطبقها، وإن طبّقتها، كانت النتيجة هي تنفير الطلبة من الأدب -هي معايير شكلية سطحية، صاغتها “لجان ضبط الجودة والنوعية” الأجنبية، دون فهم علاقتها بالبيئة التي تُطبق فيها من حيث الظروف.
ثالثاً: لا سلطة، سوى سلطة العقل، فهو الذي يتطور ويطوّر، أمّا التقنيات الشكلية الباردة، فهي مجرد أدوات قد تنفع، وقد لا تنفع. أقول ذلك، حتى لا تصبح إدارات الجامعات، حكراً على من يمتلك سيّارة فارهة، أجمل من سيارة زميله، وحتى لا تصبح إدارة الجامعات، حكراً على من يمتلك الحاسوب والانترنت والهاتف النقال، وعلى من يعلق “الفلاش ميموري” جرساً في رقبته، حيث يتوهم أنه أصبح حداثياً، بينما يمكن لسكرتيرة ماهرة أن تجيد استعمال كل هذه الأدوات أكثر من أي أكاديمي. لا سلطة، سوى لسلطة العقل المتطور الذي يبحث عن “الحداثة” في الإنسان، لا في الأدوات، وليس معنى هذا، رفض الأدوات، بل استخدامها بشكل عقلاني، لا شكلي. والأهم من ذلك، هو أنني أدعو إلى تأسيس، “المركز الوطني لبحوث العلوم الإنسانية”، شرط تأسيسه الأول، هو أنه: “لا سقف للسماء”.
 الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية



























